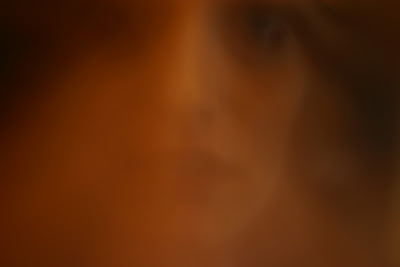أول أمس قلقت فى نومى، تقلبت فى سريرى طويلاً، ولكن وخزة فى صدرى رفضت أن تنام هى الأخرى، وتسلطت على كحجر ثقيل يرقد ممداً على رئتى ليقاوم عملية تنفسى... فإستيقظت قُبيل الفجر ، وأنا عكرة المزاج... تصفحت الجرائد وصندوق بريدى الإلكترونى، الذى وجدت به خبر وفاة والد إحدى معارفى.. فزاد ثقل الحجر الرابض على صدرى.. ولكنى رفضت الإستسلام لكآبة صباحية قد تؤدى بيومى بأكمله.. وذهبت للجرى.. عَلِى أزيح عن يومى تلك السحابة الرمادية.. ونجحت بعض الشئ فى تحسين حالتى المزاجية اللاإرادية وذهبت الى عملى لأجد مديرى متغيب عن العمل لوفاة والدته.. فعادت الى الوخزة اياها وغلفت عقلى كثافة قاتمة غير محددة المعالم.. وتحايلت على عقلى بتجاهل كل ما يزيد عكرتى الصباحية.. ومرت ساعاتى الأولى بطيئة مملة خالية من أى بهجة.. وفى منتصف اليوم هاتفت أبى وأمى - كعادتى فى مثل هذا التوقيت - ولم يجيبنى أحدهما سواء على هاتف المنزل أو المحمول.. فزادت حدة الوخز فى صدرى.. ورفضت أن أستسلم لأى إفتراضات داخلية عن غيابهما فأتصلت بأختى فى عملها لأستفسر عن غياب والدينا فقالت:
- فى البلد... بيعزوا
سألتها فى هدوء: فى مين؟
-مش هاتصدقى
فرددت عليها ساخرة: - هاحاول!!
-فى فاطمة بنت خالك أحمد أبو شادى
عند هذه اللحظة فقط أتضح لى سبب إنقباض صدرى.. انه الموت.. يحاصرنى من قبيل الأستيقاظ.. يحوم حول بشر محيطين بى.. وكأن الكون يدعونى لضرورة التأمل فى فكرة الموت... الغريب أن هدأ الألم فى صدرى.. وكأنه أنتهى من أداء الدور المحدد له ولزمت كعادتى الصمت فى مواجهة الموت.. وتفتحت تلافيف ذاكرتى عن فاطمة.. يااااااه... فاطمة ابنة خالى أحمد «ابن عم أمى» وطنط راوية... وحملتنى ذكرى فاطمة الى طفولتى فى قرية جدتى...
حيث كنا - أنا وفاطمة - صديقتين... كانت تصغرنى بأربع سنوات.. كانت هى الفتاة المؤدبة.. اللطيفة.. الهادئة، وأنا العفريتة التى لا تكف عن اللعب والتخريب.. كانت هى الجميلة.. البيضاء ..واسعة العينين... ناعمة الشعر الطويل الحالك السواد.. وأنا أم دم خفيف «كانت حيلة من أهل قريتنا كى لا يجرحون مشاعرى أنا السمراء شعثاء الشعر أمام جمال فاطمة الأخاذ»... كنا صديقتين موسميتين.. نتقابل فى الإجازة الصيفية عندما يأتى خالى أحمد هو وأسرته من الخليج وأنا أهرب من مدينتنا الصغيرة لأعسكر عند جدتى طوال فترة الإجازة.. وخلال هذا الشهر من كل عام نتقابل كل يوم صباحاً فى دوار جدى إبراهيم -جدى وجدها- وعمدة القرية لنشاهد التليفزيون ونبقى أمامه كل يوم حتى نتابع مسلسل الساعة الثانية عشر ظهراً بعد نشرة الأخبار.. بعدها يحين موعد الغداء الذى نتناوله فى أى دار من دور القرية فجميعها مفتوحة لنا.. وفى العصرية نجلس مع «ستى خُطرية» زوجة «جدى إبراهيم العمدة» نستأنس بحواديتها ونتنافس على القرب منها.. فلبدانتها المفرطة التى تمنعها من الحركة سحر خاص كان يجذبنا للأستلقاء على حجرها الرحب.. وفى «مقعد» ستى خطرية كانت تتوافد جموع النساء كل بحكاية وشكوى من نوع خاص.. وكنت أتدخل فى الحوارات الدائرة -على عكس فاطمة- فتصيبنى نظرة تأنيب من ستى خطرية كفيلة بأسكاتى لبعض الوقت.. كنا معروفتان ب» اللمضة والهادئة» .. نجوب حوارى القرية ركضاً تلاحقتنا جلجلة ضحكاتنا.. نفترق عند صلاة المغرب ونعود لنتقابل بعد العشاء على المصطبة المجاورة لغرفة الغفر.. تحكى لى فاطمة عن حياتها فى مدينتها الخليجية بكل تفاصيلها.. المبانى.. الناس .. المدرسة.. أصدقائها.. وأحكى لها عن شقاواتى اليومية فى البيت والمدرسة ومع صديقاتى وبالطبع عن مغامراتى «الخيالية طبعاً» .. يآآآه .. أتذكر الآن آخر المغامرات التى فقستها فاطمة عندما شطحت بخيالى ورويت لها «حادثة إختطافى» التى وقعت فى ذات العام:
- كنت خارجة من المدرسة تعبااانة من كتر الحصص.. وهناك ع الباب كان فى واحد راجل راكب على حمارة.. أول ماشفنى جه ناحيتى وقال لى أنت بنت فلان الفلانى .. قلت له: أيوا.. فقالى تعالى لما أوصلك عند بيت أهلك.. وراح هو راكب على الحمارة .. ومسكنى فى ديل الحمارة وركب هو فوقها .. وفضل يجرى .. يجرى .. يجرى.. ولما لقيته بعد عن المدرسة .. ومشى فى طريق تانى خالص.. عرفت بقى انه بيخطفنى.. رحت مسهياه وسيبت ديل الحمارة وطلعت أجرى .. وفضلت أجرى .. أجرى لغاية ما وصلت البيت...»
- طب ليه ما سيبتيش ديل الحمارة من الأول؟ هكذا سألت فاطمة وجاوبها الصمت
بالطبع فضحت فاطمة «فشرى» وأختلاقى للحكايات وجرستنى عند جميع أفراد العائلة .. وعُيرت لفترة ليست بالوجيزة بهذه الحكاية التى كانت آخر مغامراتى المزعومة فى الطفولة...
كنا فى الليالى القمرية نصعد الى سطح منزل جدتى ونتبادل الأحلام.. حكيت باستفاضة عن أحلامى التى كانت تدور حول إحتراف الرقص.. وروت لى مراراً عن رغبتها فى أن تصبح طبيبة وأن تتزوج من فارس الأحلام.. وروَت ورويت وجمعنا تاريخ جميل من الحكايات والأحلام.. وبعد انقضاء فترة الطفولة باعدت بينا الحياة.. وأصبحنا نتلاقى فقط فى المناسبات العائلية التى أصبحت بمرور الوقت نادرة.. صادفت فاطمة - لآخر مرة- منذ بضعة سنوات كانت قد التحقت لتوها بكلية الطب وكنت قد انتهيت من دراستى الجامعية.. كانت الأيام قد بنت حائطاً سميكا بيننا فلم نتبادل سوى كلمات تحية وجلة وكأننا نخشى أن نخسر صداقة الطفولة اذا ما اكتشفنا عمق الهوة بيننا فى ذلك الوقت.. و صدمت عندما لم أجدها طفلة صغيرة كما إعتدت عليه . فلم أعلم من قبل أنى لم أصبح طفلة الا عندما قابلت فاطمة وكانت عروسة يافع
وبعدها عدت الى منزلى ونظرت لنفسى فى المرآة أبحث عن علامات العمر فى ملامحى.. فأدركت أن الزمن الشخصى ندركه -فقط- فى وجوه المحيطين بنا..
وماتت فاطمة أول أمس.. عندما كان زوجها يوقظها من النوم فلم تستجيب له.. كانت قد فارقت الحياة بهدوئها المعتاد دون صخب .
فجر موت فاطمة فى صدرى أسئلة لا نهائية عن جدوى الحياة.. ومعنى الموت.. وعبثية القدر.. وفائدة الأحلام..
هل حققت فاطمة أحلامها؟ هل فارقت الكون الصاخب راضية مرضية.؟. أم كان لديها قائمة مؤجلة من الأحلام؟ أنا لا أبغى الخلود ولكنى ضد عبثية الموت.. من حق كل انسان أن يأخذ وجبته كاملة من الحياة.. فالموت والمرض هما عدوا الحياة .. المرض عثرة اليمة ولكنه ليس النهاية وأحيانا يكون نداء الصحوة لبعض الغافلين.. أما الموت.. فهو الحقيقة المؤكدة فى تاريخ البشرية.. فعندما يولد طفل جديد لا أحد يستطيع أن يتكهن بمصيره ولكن ما من أحد لا يعرف مثواه الأخير.. انه الحقيقة الوحيدة المطلقة فى حياتنا..
عدت الى منزلى واهنة مهزومة و»ملحمة كَلكَامش» ملك الوركاء تملأ عليّ حواسى .. وسكنتنى سخرية عميقة عندما تذكرت أنها أقدم حكاية فى تاريخ الأنسانية واسترجعت فى عقلى الجزء الخاص ببكاء كلكامش على صاحبه وأخيه الاصغر انكيدو الذي أدركه الموت”مصير البشر“ وأخذت أردد فى خيبة:
انه”انكيدو“ صاحبي وخلي الذي أحببته حبا جما
لقد انتهى الى ما يصير اليه البشر جميعا
فبكيته في المساء وفي النهار
ندبته ستة ايام وسبع ليال
معللاً نفسي بأنه سيقوم من كثرة بكائي ونواحي
وامتنعت عن تسليمه الى القبر
أبقيته ستة ايام وسبع ليال حتى تجمع الدود على وجهه
فأفزعني الموت حتى همت على وجهي في الصحاري
إن النازلة التي حلت بصاحبي تقض مضجعي
آه ! لقد غدا صاحبي الذي أحببت تراباً
وأنا، سأضطجع مثله فلا اقوم ابد الآبدين
فيا صاحبة الحانة، وأنا أنظر الى وجهك
أيكون في وسعي الا أرى الموت الذي اخشاه وأرهبه؟
ابتهجت بعض الشء عندما أتسرجعت رد صاحبة الحانة على كَلكَامش -وأنا أُسحب فى دوامة نوم ثقيل- قائلة:
الى اين تسعى يا كَلكَامش ؟
ان الحياة التي تبغي لن تجد
حينما خلقت الالهة العظام، البشر
قدرت الموت على البشرية
واستأثرت هي بالحياة
اأما انت يا كَلكَامش فليكن كرشك مليئاً على الدوام
وكن فرحاً مبتهجاً نهار مساء
وأقم الافراح في كل يوم من ايامك
وأرقص وألعب مساء نهار
واجعل ثيابك نظيفة زاهية
واغسل رأسك واستحم في الماء
ودلل الصغير الذي يمسك بيدك
وافرح الزوجة التي بين أحضانك
وهذا هو نصيب البشرية.